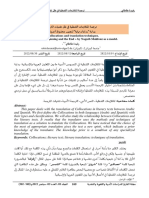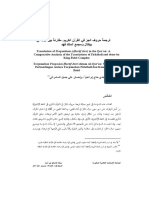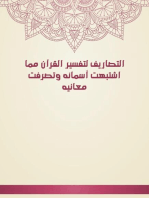Professional Documents
Culture Documents
ترجمة حصة 01
ترجمة حصة 01
Uploaded by
Hajar BeloualiCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
ترجمة حصة 01
ترجمة حصة 01
Uploaded by
Hajar BeloualiCopyright:
Available Formats
في معنى الترجمة
-الحصة األولى-
يقول صفاء خلوصي في كتابه "فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة" ،متحدثا عن الترجمة عند
العرب ،إنها كانت نشطة في عصر المأمون على مذهبين ،أولهما مذهب يوحنا بن البطريق وابن الناعمة
الحمصي وغيرهما ،وهو مذهب ترجمة األلفاظ ،وثانيهما مذهب حنين بن إسحق والجوهري وغيرهما ،وهو
مذهب ترجمة المعاني ،وقد علق سليمان البستاني على هذين المذهبين قائال إنهما المذهبان الوحيدان المعول
عليهما منذ ستة قرون وحتى يومنا هذا.
ثم تحدث خلوصي عن الترجمة باعتبارها فنا يهتم بنقل ألفاظ النص ومعانيه وأساليبه من لغته األصلية
إلى اللغة المستقِبلة ،مشي ار إلى الفوائد المتوخاة من وراء ذلك ،كتقوية ملك ِة الكتابة في لغتين وأكثر ،واستخدام
الفكر واللغة المقارنين ،وتبادل المعارف واألفكار ،ومعرفة مدى تأثير التراكيب اللغوية بعضها في بعض...
ِ
للمترجم ،والتي ركزها أساسا في االطالع على الموضوع واإلحاطة باأللفاظ ومار على الخصائص األساسية
ّاً
والمعاني ،وكذا التحلي بروحية الكاتب والسعي الحثيث إ لى ترجمة أسلوبه ،باعتبار أن "األسلوب هو الرجل"
مثلما يرى باسكال.
أما عن المدى المسموح به للمترجم حتى يتصرف في النص األصلي ،فيرى خلوصي أن عليه أن ال
يح ِّسن األصل ويصقله بإفراط ،وأن ال يبقي على األخطاء مثلما هي ،فالوسطية إذن مطلوبة بين هذا وذاك.
ويجب على المترجم أ ن يختار المعنى األنسب لسياق الكالم في كامل النص ،مع جواز اإلضافة إلى المعنى
األصلي –على سبيل التقوية -والحذف من الثانويات طالما ثبت إضعافها لقوة النص .وبخصوص الصعوبات
األساسية في الترجمة ،فقد حددها جورج كامبيل george cambellفي وجود ألفاظ معينة في كل لغة ليست
لها مقابالت في اللغات األخرى.
أما بخصوص اإللهام في الترجمة ،فيرى خلوصي أنه أمر ضروري يجعل الفرق بين الترجمة "المل ِهمة"
والترجمة "االعتيادية" ،كالفرق بين ِّ
"الشعر" و"النظم" .فالمترجم الملهم يجب أن يكون على ما كان عليه ابراهيم
المازني الذي وصفه العقاد بقوله" :استطاع بترجمته أن يرد الكالم أصيال كأنه لم يكتب قبل ذلك بلغة أخرى،
ولم يصدر عن قريحة سابقة" ،ثم يضرب لنا مثال بقطعة من رواية "آلة الزمان" للكاتب اإلنجليزي ايج .جي.
ويلز ،مترجمة على طريقتين :طريقة الترجمة "الملهمة" وهي ترجمة ابراهيم المازني نفسه على مذهب حنين بن
إسحق ،والترجمة "االعتيادية" الحرفية ،وهي الترجمة التي قامت بها نعمات أحمد فؤاد على مذهب ابن البطريق،
ليورد لنا مالحظات نعمات على ترجمة ابراهيم ،حيث أرت أن هذا األخير تخطى بعض األلفاظ دون مبرر،
خاصة مع انعدام مقابالتها في اللغة العربية ،وأنه زاد على األصل ألفاظا خال منها ،وأخي ار أنهما اختلفا حول
ترجمة بعض األلفاظ والعبارات اختالفا ّبينا.
وعن أنواع الترجمة ،يرى خلوصي أنها على ثالثة" :الترجمة الحرفية" ،وهي أضعف األنواع ،و"ترجمة
المعنى" على حساب النص الحرفي ،وهي ما قد تدفع بالمترجم إلى السهو عن لفظ لربما كان هو مفتاح النص
الرئيس ،وأخي ار "الترجمة الحرفية-المعنوية " وهي المنصوح بها وسطا بين الترجمتين األوليين .لينتهي بنا إلى
وصايا في الترجمة ،أوردها تباعا كما يلي:
.1الق ارءة األولى للنص ومحاولة فهمه فهما عاما
.2استخراج معاني الصعب من كلماته
.3فالقراءة الثانية
.4البدء في ترجمته بتدرج جملة جملة ،باحثا في كل منها عن الفعل الرئيسي ،باعتبار الفعل مفتاح
الجملة
.5إعادة موضعة أشباه الجمل (من ظرف وجار ومجرور) في مواضعها الطبيعية بعد الترجمة
.6إعادة صياغة النص باللسان األم كما لو أن المترجم هو نفسه من كتبه
على أن هنال ك طرقا مختلفة للترجمة ،تترأسها الطريقة "الصامتة" ،وتهم ترجمة الوثائق والمستندات
القانونية ،والطريقة "الصائتة" ،وتهم ترجمة الشعر والقطع النثرية ذات اإليقاع الموسيقي ،و"التصرف" وهي
ِّ
الملخصة" وهي طريقة تهم زيادة كلمات وعبارات إيضاحية في الترجمة يخلو منها النص األصلي ،و"الترجمة
االنتقال مباشرة من قراءة النص األصلي إلى كتابة ملخصه مترجما ،وأخي ار "ترجمة الفكرة" وتخص المتقنين
ألكثر من لغة ،والذين يعمدون إلى كتابة نص بلغة ثانية بعدما سبق لهم كتابته بلغة أولى.
المرجع :فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة ،د.صفاء خلوصي ،منشورات و ازرة الثقافة واإلعالم ،الجمهورية العراقية،
سلسلة دراسات ،عدد ،292دار الرشيد للنشر ،سنة 1982م.
You might also like
- نظرات جديدة في الاستعارة والترجمةDocument15 pagesنظرات جديدة في الاستعارة والترجمةBoujemaa RbiiNo ratings yet
- UntitledDocument42 pagesUntitledعبدالله الشاعريNo ratings yet
- إشكالية الحرفية و التصرف في الترجمة1Document18 pagesإشكالية الحرفية و التصرف في الترجمة1safia.belabed90No ratings yet
- ترجمة المتلازمات اللفظية في ظل تقنيات الترجمة.Document14 pagesترجمة المتلازمات اللفظية في ظل تقنيات الترجمة.naleem naleemNo ratings yet
- ترجمة لغة عربية٢Document10 pagesترجمة لغة عربية٢youmnausry666No ratings yet
- Tugas Metodologi Penelitian RevisiDocument9 pagesTugas Metodologi Penelitian Revisilaila alkatiriNo ratings yet
- الترجمة الأدبية ونقدهاDocument16 pagesالترجمة الأدبية ونقدهاallalouaniaNo ratings yet
- Tugas Metodologi PenelitianDocument8 pagesTugas Metodologi Penelitianlaila alkatiriNo ratings yet
- Makalah Kel.4 Tahlil LughowiDocument19 pagesMakalah Kel.4 Tahlil LughowiInti sari KholisohNo ratings yet
- أصوات الضمير - خمسون قصيدة من الشعر العالمي - ترجمة - طلعت الشايبDocument136 pagesأصوات الضمير - خمسون قصيدة من الشعر العالمي - ترجمة - طلعت الشايبAbdelghani JahaNo ratings yet
- Translation StrategiesDocument4 pagesTranslation StrategiesZaki AbdulfattahNo ratings yet
- الدرس الصرفي عند العرب القدامىDocument6 pagesالدرس الصرفي عند العرب القدامىMahdia TouatiNo ratings yet
- Translation Theory PDFDocument72 pagesTranslation Theory PDFChafik HAIF SI HAIF100% (3)
- ترجمة المصطلحات اللغوية السنة3 لسانيات عامةDocument12 pagesترجمة المصطلحات اللغوية السنة3 لسانيات عامةlinuchyahi1234No ratings yet
- التناص الأدبي؛ ومفهومه في النقد العربي الحديثDocument15 pagesالتناص الأدبي؛ ومفهومه في النقد العربي الحديثMetin ParıldıNo ratings yet
- المعاجم اللغويةDocument14 pagesالمعاجم اللغويةAnasNo ratings yet
- ملخص تخريج الحديثDocument18 pagesملخص تخريج الحديثUmarNo ratings yet
- PRESENTATION اللغة النصيةDocument17 pagesPRESENTATION اللغة النصيةNurul HudaNo ratings yet
- اَلتَّنْظِيرُ فِي مَجَالِ التَّرْجَمَةِDocument12 pagesاَلتَّنْظِيرُ فِي مَجَالِ التَّرْجَمَةِSofiane DouifiNo ratings yet
- Terjemahan Preposisi ( Urūf Jarr) Dalam Al-Qur'an Satu AnalisisDocument30 pagesTerjemahan Preposisi ( Urūf Jarr) Dalam Al-Qur'an Satu Analisisfahmi yahyaNo ratings yet
- ملخصDocument22 pagesملخصtoqaabdelghany1220No ratings yet
- التقابل بين التصريف العربي والإندونيسيDocument8 pagesالتقابل بين التصريف العربي والإندونيسيEdi SuyantoNo ratings yet
- Altnas Alqrany Fy Dywan Alamam Alshafy Drast WsfytDocument23 pagesAltnas Alqrany Fy Dywan Alamam Alshafy Drast WsfytVoxproduction vox donNo ratings yet
- كتاب اللغة العربية معناها و مبناهاDocument17 pagesكتاب اللغة العربية معناها و مبناهاnourazizbasmaNo ratings yet
- محاضرة رابعة في الاسلوبية وتحليل الخطابDocument5 pagesمحاضرة رابعة في الاسلوبية وتحليل الخطابAnan zeroullaNo ratings yet
- 2: Die LehrmübersetzungDocument3 pages2: Die LehrmübersetzungHollyQuinnNo ratings yet
- Xvcsds 33Document4 pagesXvcsds 33Amr GamilNo ratings yet
- المحاضرة الأولى 23 24 - 231109 - 120127 1Document3 pagesالمحاضرة الأولى 23 24 - 231109 - 120127 1heidiiibang6No ratings yet
- المقدمة في المعاجم العربيةDocument5 pagesالمقدمة في المعاجم العربيةPISMP BA2No ratings yet
- إشكالية ترجمة المتلازمات اللفظيةDocument15 pagesإشكالية ترجمة المتلازمات اللفظيةMohamedBenIssaNo ratings yet
- موقف زينب عبد العزيز من ترجمة جاك بيرك للقرآن الوجه الآخر للقرآن و الوجه الآخر لجاك بركDocument20 pagesموقف زينب عبد العزيز من ترجمة جاك بيرك للقرآن الوجه الآخر للقرآن و الوجه الآخر لجاك بركNadoushka DadaNo ratings yet
- التقابل من بلاغة الجمل الى بلاغة النصDocument24 pagesالتقابل من بلاغة الجمل الى بلاغة النصAbdullah AlawiNo ratings yet
- 939443Document225 pages939443ahmed300No ratings yet
- Traditional ArabicDocument10 pagesTraditional ArabicSyed Zain ShahNo ratings yet
- Lecon 1Document10 pagesLecon 1Abdelhak TaziNo ratings yet
- ماذا ينقد المترجم -Document3 pagesماذا ينقد المترجم -Za Hra BoultifNo ratings yet
- Ge3bi Saliha 15 24Document10 pagesGe3bi Saliha 15 24mustapha mediuNo ratings yet
- و بهاته الخاتمة نكون قد وصلنا الى أخر محطة في مذكرتنا هاتهDocument2 pagesو بهاته الخاتمة نكون قد وصلنا الى أخر محطة في مذكرتنا هاتهÆbđęł WāhäbNo ratings yet
- أثر اختلاف القراءات القرآنية في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيةDocument20 pagesأثر اختلاف القراءات القرآنية في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيةمحمد مصطفىNo ratings yet
- تماسك النصDocument17 pagesتماسك النصManar RezkNo ratings yet
- المجلة الدولية للغة العربية وادابها - العدد الثالثDocument88 pagesالمجلة الدولية للغة العربية وادابها - العدد الثالثابراهيم حسبوNo ratings yet
- (KtabPDF Com) 266853471Document116 pages(KtabPDF Com) 266853471ABD ULREZZAKNo ratings yet
- النص الشعري وأفق التحليل التداولي-قراءة تداولية لبائية الكميتDocument30 pagesالنص الشعري وأفق التحليل التداولي-قراءة تداولية لبائية الكميتInspec Ain LechiakhNo ratings yet
- علم اللغة - الترجمة إلى العربية وأثر الدلالة فيهاDocument13 pagesعلم اللغة - الترجمة إلى العربية وأثر الدلالة فيهاustman96No ratings yet
- الترجمة 1683332042908 1683466146959-ArabicDocument23 pagesالترجمة 1683332042908 1683466146959-ArabicDoha MohamedNo ratings yet
- الترجمة 1683332042908 1683466111392-ArabicDocument23 pagesالترجمة 1683332042908 1683466111392-ArabicDoha MohamedNo ratings yet
- الترجمة 1683332042908 1683466111392-ArabicDocument23 pagesالترجمة 1683332042908 1683466111392-ArabicDoha MohamedNo ratings yet
- المنهج التوليديDocument7 pagesالمنهج التوليديsoltaneamir291No ratings yet
- UntitledDocument19 pagesUntitledAbdullah Mu'ti Bin HasnanNo ratings yet
- إشكاليات الترجمةDocument18 pagesإشكاليات الترجمةHassan AhmedNo ratings yet
- Review Kitab 2Document4 pagesReview Kitab 2MUHAMMAD DANIEL BIN AZLINo ratings yet
- اللغة والأسلوبDocument69 pagesاللغة والأسلوبEnas FaragNo ratings yet
- الترجمة واستراتيجياتها واساليبها 0Document5 pagesالترجمة واستراتيجياتها واساليبها 0Fatima AlpellaNo ratings yet
- اختلاف أراء النحويين حول معاني حروف العطف ودلالتها.Document23 pagesاختلاف أراء النحويين حول معاني حروف العطف ودلالتها.muhsin sulaymanNo ratings yet
- إشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريمDocument69 pagesإشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريمMuhammad el-ZeinyNo ratings yet
- الأدب المقارن- المحاضرة الأولىDocument1 pageالأدب المقارن- المحاضرة الأولىimane toubalNo ratings yet
- Basic Ed6 23Document20 pagesBasic Ed6 23ببللاللا يكمنيكطؤNo ratings yet